هيبة الدين سند لهيبة الدولة
ما تفضل به سماحة مفتي الديار التونسية للقناة الوطنية من القول المقبول المبني على التفكر المعقول في ما يجب اعتباره من دور جامع للدين الرسمي للدولة التونسية الحديثة و هو الاسلام السني الذي يتآلف أبناء أمتنا التونسية على هديه و يتعايش في فضاء حماه كل المؤمنين بالكتاب من أهله جاء في أوانه مذكرا بأن للدين هيبته التي هي جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة والذي يمثل تسييسه استنقاصا لدوره الموحد للأفراد ليرتقي بهم الى مستوى الأمة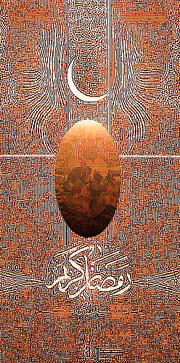 .
.
و قد كنت أوضحت في سابق المقال مما نشرته في أوانه باللغة الفرنسية تحت عنوان
« L’Aura de L’Etat »
مضاف الى هذا العنوان ما قصدته منه في لغة الضاد بترجمته بهيبة الدولة أن اغلب المتداخلين في الشأن السياسي منذ الرابع عشر من جانفي لا يأخذون في الاعتبار (بما يتماشى و أهمية الحدث التاريخي الذي تعيشه أمتنا التونسية) التفرقة الضرورية بين مفهوم السلطة السياسية من جهة و هيبة الدولة من جهة أخرى. فالسلطة السياسية لا يمكن ان تكون محل تقديس لأن ذالك يتعارض مع القاعدة المؤسسة للحكم اليمقراطي و التي تجعل شرعية الحاكم مرهونة بتجديد الشعب ثقته فيه عن طريق الصندوق الانتخابي في مواعيد يحددها القانون. فهيبة السلطة السياسية مرتبطة عضويا بما تبديه هذه السلطة من احترام لهيبة الدولة و لمؤسساتها التي تضمن لها التواصل و البقاء بصفتها الاطار المادي والجهاز التنظيمي المشترك الذي يجعل من مجموعة أفراد ِشركاء في مجتمع موحد متجاوزين الروابط العرقية والقبلية. هذه الروابط القبلية التي تجعل من الفرد ملكا للجمع الذي ينتمي له و ليس شريكا مساهما في تأسيس مجتمع وضامنا لتواصله عبر الأجيال. فجمع الأفراد الذي يتأسس على اعتبارات قبلية أو عرقية يصعب أن يتحول الى مجتمع تربط المنتمين اليه علاقة اجتماعية أساسها المواطنة. و تتمثل هذه الأخيرة في احترام الأفراد للعقد المشترك الذي يربط الحقوق بالواجبات
فالدولة التونسية التي يرجع تاريخها الى قرون و اذا ما استثنينا الفترة القرطاجنية لم تتخذ شكلا مدنيا الا ابتداء من اعلان عهد الأمان الذي فك الارتباط المفهومي بين الدولة و السلطان متجاوزا في نفس الأن الحقل المفاهيمي الخلدوني في تنظيره التاريخي لنشأة الدول على أساس التمكن من زمام الحكم عن طريق العصبية. وهو منظور ما زالت تتميز به أغلب الدول المشرقية من المنسوبة لعائلاتها الحاكمة الى التي يعاد تأسيسها أثر كل انقلاب عسكري او سياسي يسمح لعصبة سياسية عسكرية من السيطرة على مركز السلطة في انتظار الانقلاب الثوري القادم
و عدم الفصل المفهومي بين الدولة و السلطة يترتب عنه تغييب ضمني للمجتمع كمؤسسة مستقلة عمن يسوس شؤونها
ومن هنا نفهم أهمية الدستور الوضعي بصفته القانون الأساسي الذي يتجاوز حكمه حكم من سيفوضه الشعب لللاضطلاع بمهام السلطة السياسية و يجعل القول الفصل للشعب الذي هو مصدر الشرعية بصفته بانيا نفسه بنفسه وهو ما يختلف تماما عن الدساتير الاستسلامية التي لا تصاغ من طرف الانسان و تتخذ الكتب المنزلة كمرجع أزلي لتنظيم ما يتصل بشؤون الحياة الدنيا وهو موقف يمكن اختزاله في التوكل على الله مع عدم التعويل على الذات
ومن هنا كذلك جاءت أهمية التفريق بين السلطات بتنظيم ملزم لاستقلالية القضاء وتحييد ضروري للمؤسستين العسكرية و الأمنية و تمتيع الآعلاميين و المبدعين والمختصين في التعليم بمستوياته المختلفة والعلماء الباحثين من الحصانة الفكرية التي تساعدهم في القيام بمهامهم في كنف الحرية المسؤولة التي يمليها العقل الواعي بحدوده
ونستخلص مما سبق ذكره انه كلما تجاوزت السلطة السياسية بشقيها التشريعي و التنفيذي حدودها واستولت بطريقة أو أخرى على ما يرجع للدولة كمؤسسة مجتمعية وجندت في خدمتها الخاصة مؤسستي الامن و الدفاع ولم تحرص على حماية استقلالية القضاء تسببت في المساس من هيبة الدولة ناسفة في نفس الآن اسباب الثبات لحكمها و محدثة أضرارا بليغة في مقومات استمرارية الدولة و ما ينحدر عن ذلك من تشرذم للشعب و عودته الى التنظيم التلقائي البدائي المبني على غريزة حب البقاء. وان نحن سلمنا بمقولة ابن خلدون بأن الانسان مدني بالطبع فيجب ان نقبل بأن طبع الانسان ليس ما جبل عليه طبيعة ولكن ما تطبع به ثقافة و ما بالطبع يمكننا تغييره متى استقرت العزيمة على ذالك و لهذا الغرض النبيل استخلف الله عباده على الأرض مميزا اياهم عن بقية مخلوقاته بما فيهم الملائكة المقربين
وما يمكننا مشاهدته اليوم بتونس الثورة يؤكد للعيان جسامة ما وقع أثناء فترة تسلط الجنرال الجاهل على دولة تفرد ببنائها شعب تونس بقيادة رجل مثقف نظرته السياسية من انضج ما انتجه الفكر السياسي العربي المعاصر. ومن ألطاف الله ان استحواذه على جزء كبير من المؤسسه الأمنية و مساهمته المباشرة في تذييل القضاء وشكلنته للمؤسسات الحزبية و البرلمانية لم يطل المؤسسة العسكرية
غير ان ما حصل بالرغم مما اظهرته دولة بورقيبه من قدرة فائقة على الصمود امام الهرسلة التي كانت عرضة لها طيلة الثلاث و عشرين سنة الماضية يبدو و انه اضعف شيئا ما من المناعة الفكرية لجزء كبير من شبابنا وللقطاعات المهمشة من الشعب مما تسبب في ظهور مواقف ارتدادية اعادت الى سطح الذاكرة الوطنية العروشية و الجهوية التي ظننا اننا تجاوزناها منذ عشرات السنين
و ما أريد أضافته بمناسبة كلمة سماحة المفتي بالتلفزة الوطنية المشكورة على هذه المبادرة الاعلامية المسوؤولة و البناءة هو ان اقرار دستور سنة تسع و خمسين بأن تونس دينها الاسلام يجعل من الاسلام اداة لحمة بين التونسيين المسلمين و عامل طمأنينة و تعايش كريم لأقلياتنا المحترمة من أهل الكتاب و بصفته تلك يصير دين محمد جزءا من مقومات الدولة يعلو كل التوجهات الفكرية المتصلة بالسلطة السياسية٫ فمن الاجدى لنا ان لا نفصل الدين عن الدولة و ان نقوم بحماية الدولة و دينها من فعل السياسيين المتسلطين
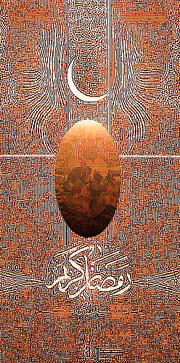 .
.
Une réponse
Ezzedine Knani
أفهم من مقالك أن الدين جزء من الهوية ولا مجال لفصله عن الدولة وكأني بك تقحم الدين اقحاما في الدولة فتنزع عنها مدنيتها رغم اعترافك بمقولة بن خلدون الذي يرى أن الانسان مدني بطبعة وحسب فهمي البسيط أن لا يكون الدين عائقا دون تطوره ومواكبته لأي عصر يعيش فيه،وكأني بك لم تر موجبا لعلمانية الدولة وهي سبب هزيمة رجال الدين في مجال الحكم، لا باعتبارها فصل الدين عن الدولة اطلاقا أنما اعتبار العقيدة الدينية هي مسألة الفرد في علاقته بخالقه وهكذا لا تضيع هويته،فالعلمانية هي اذن متعلقة بضرورة أن تقوم الأخلاق والتعليم على أساس غير ديني من غير تدخل في عقيدة الفرد واعتبرت كذلك على أنها تقوم على العلم والمعرفة فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة.
ونحن نعلموان العلمانية تعود جذورها الى الفلسفة اليونانية القديمة وظهرت في أوروبا كما تعلمناه في القرن السابع عشر ميلادي ومن دعاتها فيما قراناه في النصوص الادبية الفرنسية فولتير وجان جاك روسو وانتقلت الى الشرق خلال القرن التاسع عشر ومن روادها قاسم أمين.
.